هرم خوفو
كما أن النسبة الذهبية موجودة في الأشكال الهندسية المستوية، كذلك نجدها في الأشكال الفراغية؛ وأهمها رباعي الوجوه المنتظم، والمكعب، وثُماني الوجوه، وذو الـ12 وجهًا، وذو الـ20 وجهًا (وهي ما يُعرَف بالمجسَّمات الأفلاطونية).
ففي ذي العشرين وجهًا مثلاً، إذا وصلنا بين الحرفين المتقابلين تكون المسافة φ إذا كان طول الحرف يساوي 1. وإذا لم يكن المجال يسمح لنا بدراسة هذه المجسَّمات التي كان أفلاطون قد صنَّفها، فإننا سنكتفي بإلقاء الضوء على أحد أشكال رباعي الوجوه، ولعله أشهرها على الإطلاق، هرم خوفو.
إذا أخذنا مسقطًا شاقوليًّا يمر من منتصف ضلعي المربع القاعدة، فإننا نجد مثلثًا متساوي الساقين، طول كلٍّ منهما φ، وارتفاع المثلث هو ارتفاع الهرم، ويساوي ، هذا إذا اعتبرنا أن قاعدة المثلث تساوي 2؛ أي أن هذا المثلث مؤلَّف من مثلثين ذهبيين. ويشير هيرودوت إلى التناسبات القائمة في الهرم بقوله: "لقد أعلمني الكهنة المصريون أن التناسبات المُقامة في الهرم الأكبر بين جانب القاعدة والارتفاع كانت بحيث تسمح بأن يكون المربع المُنشأ على الارتفاع يساوي بالضبط مساحة كلٍّ من وجوه الهرم المثلثة." ترى هل إنشاء مثل هذا المربع كان يُقصَد منه الإشارة إلى العلاقة بين π وφ، حيث إن العدد π قائم في الهرم من خلال نسبة الارتفاع إلى نصف محيط القاعدة؟ على أية حال، يجب أن نلاحظ أن خصائص هذا الهرم توافق كلَّ هرم ميله 14/11 ( الموافق لزاوية ميل 51 درجة و50 دقيقة و35 ثانية)، وهي بالتالي لا تخص هرم خوفو فقط. فقبل حكم هذا الملك كانت هذه النسبة موجودة في هرم ميدوم عندما كان غطاؤه لا يزال موجودًا. ويثبت ذلك أن هذه النِّسَب كانت موجودة في مَيَلان واجهات الأهرامات في السلالة الثالثة. والسؤال المطروح هو: هل كان المصريون القدماء يعرفون هذه النِّسَب منذ ذلك الزمن السحيق، أم أن اختيارهم لهذا النموذج كان من قبيل المصادفة؟ إن الحفاظ على هذا النموذج بهذه القياسات الدقيقة لا يحمل سوى معنى واحد باعتقادي، وهو أن المصريين عرفوا هذه النِّسَب، وحافظوا عليها في سرية فائقة منذ أزمنة موغلة في القدم!
من جهة أخرى، إذا رسمنا قطعًا ناقصًا محوره الصغير هو ضلع المربع في قاعدة الهرم، فإن نصف محوره الكبير سيساوي φ، وسيقع محرقُه عند ذروة الهرم. ترى هل كان المصريون يعرفون ذلك؟ نحن لا نعرف شيئًا عن معلوماتهم حول القطع الناقص؛ لكنهم كانوا فعلاً ينسبون ذروة الهرم إلى الشمس. يقول موريه A. Moret، أحد كبار علماء المصريات: "لقد وجدنا صدفة الذروة الهرمية pyramidion التي كانت تعلو هرم أحد الملوك من السلالة الثانية عشرة، وهو لأمنحوتب الثالث، في دهشور. وكان هذا الحجر الجميل من الغرانيت منحوتًا ومصقولاً كالمرآة، ويحمل على جهته الموجهة نحو الشرق قرصًا مجنحًا...". كانت هذه الذروة تعكس أشعة الشمس من الشروق حتى الظهر، فتبدو كأنها شعلة في ذروة الهرم. ونعلم أن كلمة هرم pyramid مشتقة من الجذر اليوناني πύρ الذي يعني "نار". فإذا أبحرنا في الخيال وقرنَّا الشمس إلى الذهب – والذهب كان رمز النار والشمس والإله رَعْ عند المصريين القدماء – لكان من الممكن أن يسمِّي المصريون العدد الذهبي "عدد الشمس"، الشمس مولِّدة الحياة على الأرض!
الكلام على الهرم لا ينتهي. لكننا نشير في النهاية إشارة سريعة إلى نوع آخر من المجسَّمات الذهبية، هو متوازي المستطيلات الذهبي، وأضلاعه هي 1 وφ و2φ، وحجمه يساوي 3φ؛ أي أنه يساوي حجم مكعب ذهبي. ويحقق هذا الشكل متتاليتين: عددية (1, φ, φ + 1 = 2φ) وهندسية (1, φ, 2φ). وهذا أمر خاص بالنسبة الذهبية؛ ذلك أننا لو طرحنا مسألة إيجاد عددين بحيث يشكلان معًا متتالية هندسية وعددية لتوصَّلنا إلى المعادلة الأساسية x2 = x + 1؛ وحلها هو ببساطة العدد الذهبي. ويمكن لنا بالطبع تعريف عدة أشكال من المستطيلات الذهبية؛ لكننا نكتفي بالإشارة إلى أن غرفة الملك في هرم خوفو تحقق تناسبات ذهبية، وأضلاعها هي 2، 4، .
العدد الذهبي في الحياة
تحمل التفاحة – ثمرة شجرة معرفة الخير والشر – رمزية فائقة. وقد اعتاد دارسو الأساطير الكشف عن أحد وجهي رمزيتها من خلال تجزئتها إلى قسمين طوليًّا، بحيث تظهر رمزية المرأة، القطب السالب، الجاذبة للإنسان إلى ثنائية الخير والشر. لكن قلَّة من الدارسين قطعوا التفاحة عرضيًّا وشاهدوا المضلَّعات الذهبية – الوجه الآخر الإيجابي. وإذا تمعنَّا في المضلَّع المرتسم أمامنا سنلحظ مخمَّسًا يحوي البذور، ثم مخمسًا آخر غير واضح كالأول، سرعان ما يسودُّ مع جفاف التفاحة، ليشكِّل مع الأول مضلعًا من عشرة وجوه. وفي كلٍّ من هذه المضلَّعات الذهبية نستطيع أن نستشف معنى جديدًا للأسطورة القديمة!
والتفاحة ليست استثناء. فكافة الأزهار الخماسية الأجزاء تحقق هذه النسبة. قد يعترض بعضهم قائلاً إن أزهارًا أخرى رباعية أو سداسية أو سباعية الأجزاء إلخ لا تمثل النسبة الذهبية. لكن الإجابة على هذا السؤال جاءت في العام 1875 على يد فينر Wiener، الذي وجد أن الزاوية 137 درجة و30 دقيقة و28 ثانية التي تظهر غالبًا في نموِّ الأوراق في أثناء التباعد الحلزوني الثابت لفروع التيجان – وهي زاوية تنتج عن حلِّ معادلة النسبة الذهبية، وتساوي ، وتوافق الحلَّ الرياضي لمسألة التوزع الأمثل (يكون الأقصى في المناخ المعتدل) للأوراق، بحيث يكون الضوء الواصل محوريًّا أو عموديًّا. وقد دُعِيَتْ هذه الزاوية بالزاوية المثلى، وتساوي .
إن وجود هذه النسبة في النبات يجعلنا نبحث عنها في الحيوان أيضًا. لكن حرية حركة الحيوان وتعقيد بنيته يجعلنا نتساءل عما إذا كان كَسْر التناظر قد بلغ حدًّا أخفى معه هذا التناسب الطبيعي البسيط. لكن مهلاً... عندما تكون هذه الحرية محدودة، كما عند بعض الحيوانات شبه الثابتة، مثل نجمة البحر ذات الأطراف الخمسة، وكافة الرخويات التي تثقل القواقع على حركتها، نجد أن النموَّ يتم عبر حلزونات مخروطية تتبع المتتالية اللوغاريتمية أو الحلزون الذهبي. أما عندما تكون الحرية أكبر، فإنه يصعب إيجاد هذه النسبة؛ غير أن هذا لا يعني عدم إمكانية التوصل إليها. لقد حدَّثتنا العصور الوسطى كثيرًا عن الإنسان الكوني المرسوم في مخمَّس. ويبدو أن الإنسان ينمو حقًّا وفق النسبة الذهبية. فوجه الإنسان يرتسم في مستطيل ذهبي؛ وهذا المستطيل يحمل تقسيمات ذهبية لأعلى الجبهة ولأسفل الأنف ولمستوى الفم ولأسفل الذقن. إضافة إلى ذلك، إذا رسمنا مسقط الهرم الشاقولي ضمن هذا القطع لوقعت ذروةُ الهرم في مستوى الغدة الصنوبرية عند الإنسان. كما وتمثل هذه النقطة ذروة الجبين، حيث كان الكهنة المصريون يقرنون ذروة الهرم إلى الشمس المجنَّحة وذروة الجبين إلى رمزَي مصر الدينيين التقليديين: النسر والثعبان. ترى، أي مكان أروع للرمز إلى العين الثالثة – عين البصيرة في الإنسان؟
ولكن ماذا عن الجسم الإنساني وعن حركته؟ يقول رودلف لابان M. Rudolf Laban، مدير إحدى أشهر مدارس الرقص الإيقاعي في ألمانيا: "إن كلَّ حركات الجسم الإنساني في الأبعاد الثلاثة تؤدَّى في شكل أمثل بانتقالات زاوية تقدر بـ72 درجة، وإن مختلف الاتجاهات في الفضاء الموافقة لهذه الانتقالات تمثَّل بأقطار مجسَّم منتظم من عشرين وجهًا، حيث تشكِّل الزاوية 72 الزاوية المركزية في أحد وجوهه المخمَّسة." ويقول معلِّم الرقص: "إن الحركات المتناغمة هي التي تقود الخطوات وحركات الذراعين واليدين والنظرات باتجاه قمة المجسَّم."
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ولعل النسبة الذهبية تبرز أكثر ما تبرز في التناسب الطولي للإنسان. فنسبة طول الإنسان إلى ارتفاع سرته عن الأرض تساوي أو تقارب كثيرًا النسبة الذهبية. وقد بيَّنَتْ الدراسات الإحصائية صحة هذه النسبة في معظم التماثيل اليونانية القديمة. ومن خلال دراسة إحصائية للأجناس البشرية تبيَّن أن بعضها يمثل هذه النسبة تمامًا، في حين أن الأجناس الأخرى تقترب منها. وفي كلِّ حالات عدم تحقق النسبة، لم يقع خط النسبة الذهبية فوق السرة، بل تحتها. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الطفل الوليد لا ينمو بتناسب ثابت في كافة أعضائه بسبب قصر طرفيه السفليين، نستطيع الاستنتاج أن النموَّ الإنساني يقترب في سنِّ النضج من تحقيق النسبة الذهبية.
إن الحديث عن النسبة الذهبية يكاد أن يكون بلا نهاية. ويسعى باحثون كثيرون اليوم إلى اكتشاف أسرارها في الطبيعة، أو البحث عنها في الإنجازات الإنسانية القديمة، أو إلى استلهامها في حياتنا اليومية. ونشير هاهنا، مثلاً، إلى أنه قد تبيَّن أن السلَّم الموسيقي الذي وضعه وأرسى أسُسه النهائية باخ يكاد أن يطابق السلَّم الموسيقي المبني على النسبة الذهبية. كما أن جمال آلة الكمان الذي يُجمِع عليه معظمُ الموسيقيين والناس يُخفي حقيقة جوهرية كما بيَّنت آخر الدراسات: فالكمان مبني وفق تناسبات ذهبية دقيقة. ويبدو أن انتصار عصر النهضة لهذه النسبة أدى إلى اكتمال شكل الكمان وفقها. أما في العمارة الحديثة، فعلى الرغم من أن نموذج لوكوربوزييه Le Corbusier هو محاولة فيها بعض الإقحام، لكنه نموذج فريد يربط بين سلسلتين لفيبوناتشي بأبعاد المنزل السَّكَني مستنتَجة من أوضاع وحركات الإنسان في داخله. ونشير أخيرًا إلى أن متتالية فيبوناتشي تدخل اليوم في مجال نظرية البحث وفي العديد من الأبحاث العلمية والرياضية.
الجمال والمعرفة
لطالما تساءلتُ، وأنا أتأمل تنوع الجمال الطبيعي، عما إذا كان للمعرفة الإنسانية أن تكتمل ما لم تُتوَّج بقدرة فائقة على اكتناه أسرار الجمال. ولتساؤلي هذا ما يبرره، مادام جاذبٌ خفي يشدنا إلى سحر غامض في ألوان الطبيعة وأشكالها اللانهائية التنوع. ومما لا شكَّ فيه أن هذا الجاذب ما كان ليكون موجودًا لولا أن الإنسان نفسه كائن طبيعي. وعلى تخوم هذه الوحدة يتسنَّم تساؤلي ذروته: لعل المعرفة ليست في جوهرها سوى تجلِّي الجمال في أبهى مظهر له، ألا وهو التواحد مع الطبيعة؟! بل لعل دافعي الحقيقي إلى المعرفة هو الجمال المكنون فيَّ – هذا الجمال الذي يسعى إلى التألق بجمال الكلِّ وإلى وعي ذاته في جمال الوجود؟
كذا فإن القانون الطبيعي هو قانون الجمال في نهاية الأمر؛ وإدراك قوانين الطبيعة هو كشف لقوانين الجمال. وضمن هذا المنظور، يختلف مفهومُنا للجمال، كما ومفهومنا للقانون الطبيعي. فالجمال النسبي الذي قد نختلف على مقاييسه ودرجاته يتبدَّد في ضوء الجمال الطبيعي الذي نستلهمه من وعينا للطبيعة؛ ذلك أن هذا الجمال هو قانون الطبيعة بذاته. وفهمنا لهذا القانون لا يمكن له أن يكتمل ما لم نكتمل نحن به. فحياتنا مظهر له، والوجود مظهر له. وكلما أغرقنا في فهم الطبيعة بعيدًا عن روح هذا القانون جرَّنا فهمُنا هذا إلى متاهة لا مخرج منها.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
كذا تتسنَّم الطبيعةُ ذروةَ جمالها عندما تصبح قادرة على فهمه ووعيه والتعبير عنه. وذلك لا يعني أن الجمال لم يكن موجودًا قبل وجود الإنسان. غير أن بزوغ الفكر، وظهور ثنائية العارف والموضوع المعروف، التي نجمت عن انكسار داخلي في الطبيعة المتطورة، أدى إلى انكسار ظاهري في مرآة الجمال. فقد ميَّز الفكرُ نفسه عن الطبيعة وحاول إدراك قوانينها في معزل عن طبيعته. ولنقل إن صيرورة الطبيعة نفسها هي التي أدَّتْ إلى هذا الانكسار في تناظرها التطوري، لأنها كانت تريد رؤية نفسها في مرآتها الخاصة. لكن ذلك لم يشكِّل شرخًا حقيقيًّا لأن الإنسان في النهاية كائن طبيعي تفعل فيه قواعد الجمال الطبيعي.
يمكن لنا القول، إذن، إن المعرفة الإنسانية لا تشكِّل سوى طور من أطوار الصيرورة الطبيعية. وقد يؤدي انكسارٌ ظاهريٌّ آخر في هذه المسيرة إلى ظهور قدرة معرفية أوسع وأشمل من قدرتنا. إلا أن تتالي مثل هذه الانكسارات لا بدَّ أن يؤدي إلى تعميق القانون الطبيعي الأصيل. ونلاحظ في استمرار أن تميُّز الإدراك وتجليه ينعكس على الشكل المدرِك. وهذه العلاقة بين الظاهر والباطن، بين الشكل والقانون، هي التعبير الأعمق – دون شك – عن القانون الحقيقي الذي يرتكز عليه وجودُنا.
كيف نستطيع، مثلاً، إدراك تاريخنا المعرفي إذا لم نلحظ هذا التوازي بين التغير الشكلي والانكسار الداخلي؟ لا شكَّ أن الإنسان القديم كان قريبًا من الطبيعة في شكل مختلف عن قُربنا منها؛ وكان تناغمُه معها يرتكز على مقدرته على إدراك وجوده فيها كجزء منها. ومن هنا فإن مسؤوليته كانت موجَّهة، بالدرجة الأولى، إلى بَلْوَرَة هذا الإدراك. وما الأساطير القديمة إلا الشكل الجمالي لهذه المرحلة. أما اليوم، فإننا لا نستطيع الاكتفاء بهذا التوجه. فمع إدراكنا لموقعنا في الطبيعة، لا بدَّ لنا من تركيز جهودنا على إدراك موقعنا المعرفي. تلكم هي مسؤوليتنا الأولى. ومن هنا يمكن لنا أن نبدأ ببناء الأساس المعرفي للإنسان المقبل. وعلينا أن ندرك أن أيَّ انكسار في الصيرورة الطبيعية لا يؤدي فقط إلى ظهور تعقيد أكبر في الشكل الفسيولوجي وفي المقدرات النفسية والعقلية، بل وإلى ظهور مقدرة فائقة وأكثر تطورًا على التبسيط وعلى إبراز المعنى الأكثر نقاء للتجريد المعرفي.
هكذا يمكن لنا، منذ الآن، التنبؤ بالشكل العام لتطور الصيرورة المعرفية. وإذا تتبَّعنا مسيرة التطور النفسي والعقلي للإنسان، كما ومسيرة إنجازاته الشكلية، لثَبَتَ لنا أن أيَّ تصور مستقبلي للمعرفة البشرية يجب أن يرتكز على تطور لوغاريتمي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا هو: أليس من ضابط لهذا التطور المتسارع؟
لربما كان الأمر يتعلق بالإنسان نفسه، وباختياره، منذ الآن، لمتتالية تناغمية تحكم مسيرته المعرفية وتحيد به عن دربَي الإفراط أو التفريط على حدٍّ سواء! لقد بلغ إنسانُ اليوم مقدرةً هائلة على التجريد، مما يوفر له الفرصة لفهم صيرورته المعرفية فهمًا أشمل. غير أننا لا نستطيع قياس رياضيات القرن العشرين بتجريدها فقط، بل وبذاتيتها التي تمثل باطن تطورها. فمع تشعب العلوم الرياضية ثمة ميل مقابل إلى الشمولية والفهم الذاتي، لعله بَرَزَ لأول مرة، وفي أوضح أشكاله، مع أعمال غودل Gödel العظيمة. ومن هنا يمكن لنا أن نرى إلى مسيرة الرياضيات المستقبلية.
ويتطلع العلماء، منذ اليوم، إلى قمة بعيدة وشامخة تتناسب مع القاعدة التي أسَّسوا لها. ولعل هذه القمة تخترق سماء إدراكنا الحالية، وتتجاوز طبقات جوِّنا الصاخب. إنها قمة للجمال الصافي وللبساطة الصافية وللكلِّية الصافية.
من هنا، فإن التوجه الذاتي للرياضيات، ربما نحو تجريد متزايد ظاهريًا، سيؤدي حتمًا إلى بناء هيكل معرفي، لا نعرف شكله أو حدوده بعدُ، لكننا ندرك في وضوح أنه يستمد مواده من منطق أعظم تناسقًا وجمالاً من منطقنا، وبالتالي أبسط منه. إن محاولة بناء خوارزمية للمعرفة، مثلاً، لا يقارَن بالجهود المبذولة اليوم لبناء حواسب عملاقة أكثر فأكثر مقدرة. ومن المرجَّح أن ما من أحد من العاملين في هذا المجال انتبه إلى أن الإمكانات الذاتية تحتاج إلى وقت لتنضج، أي ليصبح في الإمكان توجيه مقدراتنا المعرفية. ولا شكَّ أن إنسان الغد سيحمل عبء التخلص من أخطائنا. إن الشكل المعرفي ليس بأقل أهمية من المعرفة ذاتها؛ وعدم ضبطنا اليوم لتوجهاتنا المعرفية لا يتوافق والقواعد الجمالية المنحوتة في أعماقنا. فالمعرفة ليست جهدًا فوضويًّا، وليست تراكمًا للمعلومات وسبرًا عشوائيًّا للظاهرات؛ بل إن المعرفة ليست بناء نظريات فيها الكثير من خصوصيات بُناتها والقليل من روح الجمال الطبيعي.
لقد تجاوزت الرياضيات اليوم مجرد كونها حقلاً للقياس أو للتطبيق الفيزيائي، وباتت طريقًا إلى المعرفة وموئلاً لمريديها. والمعرفة، من هذا المنظور، تتجاوز المنهج الذي يقوم على النظرية والبرهان: فهي تتأسَّس في بساطة على التناسق الكامل في البناء الشكلي البحت. وإذا كان هذا التناسق كليًّا، فهو لن يؤدي إلى نظريات مختلفة، بل إلى صيرورة معرفية موازية للصيرورة التطورية الطبيعية. وعلى هذا، فإن الشكل المعرفي ليس نهائيًّا، بل هو شكل متفتح باستمرار عن جمال أخَّاذ لا ينفك يتفلَّت من إسار الفرضيات ويغوص أكثر فأكثر في وحدة الشكل والجوهر.
كذا يكون لكلِّ عصر معرفته الكلِّية. لكن هذه المعرفة ليست نظرياته ومعلوماته، بل الشكل الفنِّي لهذه النظريات والشكل الذاتي لهذه المعلومات. إن معرفتنا الحقيقية هي الشكل الجمالي لقدرتنا التعبيرية في نظرياتنا وأفكارنا. ومقياس حضارتنا هو إدراكنا لهذه الحقيقة وعدم الانغماس في ظاهر إنجازات علومنا.
***
إنَّما الجمال انعكاس للحقيقة في الوجود. تلكم هي ركيزة كلِّ معرفة. فالجمال والمعرفة صنوان. وكلاهما لا يفترقان عن ال
حقيقة، لأن "الحقيقة جمال – إنها حقيقة الجمال"، ولأن المعرفة جمال، إنها تحقيق الجمال. ويمثل هذا الثالوث الوجود في كلِّيته وفي وحدته وفي صيرورته. فالحقيقة هي الكل، والجمال هو الوحدة، والمعرفة هي الصيرورة. إن المعرفة والجمال وجهان للحقيقة: فالجمال باطن المعرفة، والمعرفة ظاهر الجمال. والظاهر لا يتحقق إلا بكمال الباطن؛ كما أن الباطن لا يتحقق إلا بكمال الظاهر. وكمال المعرفة المحبة، وكمال الجمال المحبة.

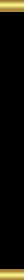

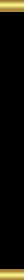


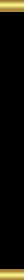

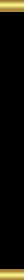

 رد: النسبه المقدسه
رد: النسبه المقدسه





